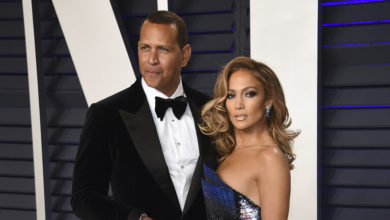“مرايا التحولات الرقمية” .. كتاب يأخذك إلى اللانهاية
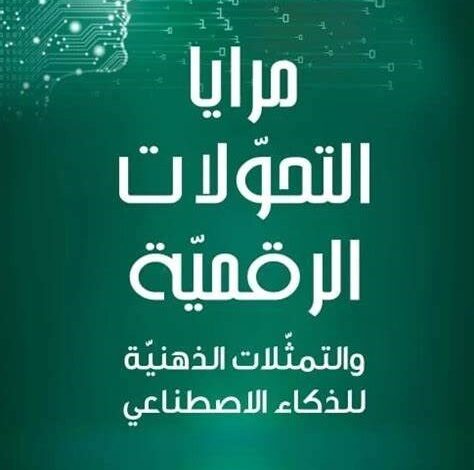
بقلم كمال مساعد
يشير الكتاب إلى ماهيّة الثورة الرقمية والتغيير الذي أحدثته في معادلة القيم، وإلى الخطر الذي يهدد وجودنا مباشرة وغير مباشرة بسبب التغيُّرات الناتجة من الرقمنة والتحرك نحو «ثقافة أحادية».
التحوّل الرقمي ليس خطاباً، بل هو تمثُّل للمعرفة مقرون بفعل وممارسة، فعندما يدرك المجتمع أن الرقمنة والثقافة الرقمية هما رؤية شاملة للحياة، يصبح بمقدور المجتمع تأطير التحوّل الرقمي في قواعد والركون إليها، هكذا يعتبر الدكتور غسان مراد في كتابه “مرايا التحولات الرقمية”.
الكتاب هو مجموعة من التداخلات الشائكة ما بين جدلية حوسبة اللغة والإعلام الرقمي، وإشكالية ومتاهات اللغة والفلسفة وعصبيات الدماغ والرياضيات في جدلية لا تنتهي؟، لأن المؤلف يعتقد أن التقنيات الرقمية غيرت في رؤيتنا للعلاقات الخاصة والعامة، للسلوكيات وللقيم الاجتماعية، والأدوات الحياتية ومستلزماتها، لهذا يمكن اعتبارها حضارة جديدة لأن تأثير هذه الخصائص المتغيرة يؤدي إلى تعديل في ثقافتنا الفردية والمجتمعية. كل هذا التغيير وأثر الرقمنة على حياة الفرد، يؤديان إلى تغيير في هوية الفرد وبالتالي الانتقال إلى ما يسمى الهوية الرقمية، فالهوية ليست الموروث الجيني، بل هي مجمل التأثيرات الحياتية والثقافية كمفهوم عام باتت الرقمنة عماده.
الكتاب يقسم الى أربعة فصول ويقع في 200 صفحة من القياس الكبير، صادر عن دار شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في العام الحالي 2022.
يعالج هذا الكتاب بعض الإشكاليات المتعلقة باللغة والدماغ، ويطرح أهمية تحديد المفاهيم الأساسية لهذا التحول الرقمي انطلاقاً من الدماغ والفكر، وصولاً إلى الدور الذي تؤديه اللغة الأم في مواكبة كل أشكال التطور. ويؤكد المؤلف على دور لغتنا الأم، اللغة العربية كلغة علوم. كما يعالج علاقة اللغة العربية بالرياضيات وكيف يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في حوسبة هذه اللّغة.
الثورة الرقمية
يشير الكتاب إلى ماهيّة الثورة الرقمية والتغيير الذي أحدثته في معادلة القيم، والمواقف التي اتخذت إزاء وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة هذه الثورة، وكذلك إلى الخطر الذي يهدد وجودنا مباشرة وغير مباشرة بسبب التغيُّرات الناتجة من الرقمنة والتحرك نحو «ثقافة أحادية» رقمية، وبالتالي نحو إفقار إنساني أساسي. لأن الرغبة المتهورة في تقديم الرقمية كمرجع إدراكي، ووضعها في طليعة نطاقنا الوجودي والسباق المستمر نحو كل ما هو رقمي تمهد لتغيير جذري سوف يلقي بظلاله على إنسانية الفرد وهويته.
كما تتمثل الأهداف الرئيسة لهذا الكتاب في إبراز صورة لماهيّة الثورة الرقمية وما أحدثته من تغيير في معادلة القيم، واتخاذ موقف بشأن وسائل التواصل التي نتجت منها، من خلال عرض بعض ما يمكن أن يشكل تهديداً مباشراً وغير مباشر للأفراد بسبب التغيّرات الناتجة عن الرقمنة، والشعور الجديد الذي تثيره في البشر.
يلاحظ المؤلف غسان مراد، أنه قبل ظهور البرمجيات، من كان «يتخيل» القدرة على التواصل بصرياً، وفي الوقت نفسه، مع أي شخص على الجانب الآخر من الكوكب؟ من كان يتصور أن عملية الوصول إلى مصادر المعلومات ستكون سهلة ومرنة بهذا الشكل؟ كما لم يكن بالإمكان تخيّل هذا الانفتاح على كل الثقافات؛ فاليوم، كما بات معلوماً وممارساً، أصبح بالإمكان الحصول على الملفات بكل أنواعها (موسیقى، صور، فيديو…) بامتلاك جهاز تقني واحد بحجم كف اليد.
بناء على ذلك، تحدد المفاهيم الأساسية انطلاقاً من الدماغ والفكر، وصولاً إلى دور اللغة الأم الذي تؤديه في مواكبة كل أشكال التطور والابتعاد عن أشكال التقليد والتقييد الفكري كافة. استطراداً، إن لغتنا الأم، اللغة العربية، هي لغة علوم، فالانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج هو الأساس في أي عملية تطور، وذلك من خلال استخدام البيانات والمعرفة، بهدف خلق معلومات جديدة ومعرفة جديدة.
كما يشير المؤلف الى انه على الصعيد الأكاديمي، يجيب الكتاب عن التساؤل التالي: ما مدى أهمية إدخال المعلوماتية إلى كليات الآداب والعلوم الإنسانية؟ فلكي تواكب اللّغة العصر، أليس من المهم تدريس العلوم والمعلوماتية باللغة العربية وتدريس المعلوماتية كعلم في العلوم الإنسانية؟
ولما كنا في مرحلة اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على الرقمنة والبرمجيات، هل يكفي إدخال المعلوماتية إلى الجامعة فقط أو يجب إدخالها أيضاً في مناهج التعليم الأساسي؟ وما أهمية ذلك في تهيئة الأجيال الجديدة كي تدخل علميًّا ومعلوماتيا في سوق العمل؟ ثم إن تعليم البرمجة يتعلق بتعلّم المنطق، ألا يساعد ذلك في التحول نحو التربية على النقد وطرح الأسئلة والخروج من ثقافة التلقين المعتمدة حتى الآن في التعليم؟ وما هي أهمية ربط المواد الأساسية مع المعلوماتية، والأكاديمية في ما بينها؟
يحاول امراد في كتابه طرح رؤية تصف ما يتغير في تجربتنا في العالم، وتصف الإمكانيات الهائلة للإثراء التي تنطوي عليها، من خلال عرض بعض المشاريع المبتكرة. ولا يرتبط التحول الرقمي بالضرورة بالتكنولوجيا الرقميّة، بل يرتبط بحقيقة أن التكنولوجيا الرقمية تمكّن الناس من حل مشكلاتهم التقليدية باستخدام الحلول الرقمية. بمعنى آخر، لا يمكن إيجاد حلول لتساؤلات جديدة من خلال مفاهیم قديمة. استطراداً، حتى التعريفات ستطرح هذه التساؤلات، (هل هي ما بعد الكون أو ما وراء الكون أو ما فوق الكون؟ هل هي أبعد من الكون الواقعي؟ أم أن من يدخل هذا العالم يتفوق في فكره وفي قدراته عن الحالة التي يكون فيها في الواقع؟ أما سؤال ما وراء الكون، فيدخلنا في عالم الماورائيات ويطرح أسئلة وجودية فعلية سيكون النقاش فيها مستقبلاً لدراسة الحالات الناجمة عن التغيّرات الذهنية وصورة العالم ورؤية العقل)، الذي سيتفاعل ویری في مكان لا يوجد فيه الجسد. وستطرح من جديد النقاشات الفلسفية حول الثنائية الديكارتية للعلاقة بين الجسد والعقل… وهي نقاشات متجددة تجمع بين التطور في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، ومسائل تطرح في الكتاب تتعلق باللغة كوسيلة للتعبير عن الفكر وفي ما له علاقة بحاسة الشم وقدرة خوارزميات الذكاء على تخطيها.
أهمية التكنولوجيا في عصرنا الحاضر
في الواقع، لقد جعلت جائحة كورونا التكنولوجيا الرقمية ضرورية في حياتنا؛ سواء كان الأمر يتعلق بالتعلم، أو العمل، أو التواصل مع الأقارب. وفي هذه الحالة ندرك مدى انطباق المثل القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد». ففي منتصف العام 2021، استغل مارك زوكربيرغ علامة الميتافيرس وأعلن عن تعديل إسم مؤسّسته إلى ميتا، ثم قام بتشكيل فريق عمل من عشرة آلاف موظف لبدء بناء مثل هذا الفضاء في شبكة التواصل فيسبوك ليكون السباق إلى التغيير، بالأخص أن فيسبوك بات إمبراطورية تجمع أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.
إن الأسئلة التي يمكن أن تطرح بهدف معالجة هذا الموضوع متعددة ولا يمكن الإجابة عنها في الحاضر، فما الذي سنفعله بهذه الميتافيرس؟ هل ستكون شكلاً من أشكال ما بعد الإنسانية التي ستزيد من قدراتنا؟ هل ستؤدي إلى التفكير في طريقة جديدة للعيش أكثر توافقا مع القيود البيئية؟ هل ستُبنى وفق التفكير الأخلاقي والقيمي للبشر وليس للشراكات التجارية فقط؟
لقد تطورت قدرات الباحثين في التعرّف إلى كثير من الأمور المتعلقة باللغة، بفضل أدوات قياس حركة الدماغ، من خلال التصوير بالرنين المغنطيسي. هذا الأمر على درجة عالية من الأهمية، لأن اللغة تشكل كفاءة تتمتع بها الأجناس البشرية كافة. وتطورت هذه الكفاءة عبر العصور، ومنذ آلاف السنين، وهي تمتلك أدوات هيكلية عصبية فيزيولوجية يراقبها الباحثون من خلال الرنين المغنطيسي.
أثبت الباحثون أن التواصل موجود عند الكائنات الحية كافة (مثلاً: التواصل عند الحيوانات عبر إطلاق إشارات كيميائية أو فيزيائية)، لكن ما يميّز التواصل عند الجنس البشري هو إمكانية التوافق على الإشارات والرموز التعبيريّة، وتنوّع أدواتها وأساليب استخدامها، لتصبح معیاراً يحدد معاني معيّنة.
الخريطة الدماغية
يشير المؤلف الى انه في أوائل القرن العشرين، اكتشفت الخريطة الدماغية، ثم ظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي، وكان الدماغ محور الدراسات والبحوث، لأن فهم الآليات التي يعمل بها الدماغ تؤدي إلى تطور في بناء آلات تحاكي الذكاء البشري. وفي الوقت نفسه، كان للتطور التقني دور في فهم الدماغ، من خلال تطور آلات التخطيط الكهربائي للدماغ وأدوات التصوير بالرنين المغنطيسي والرنين المغنطيسي الوظيفي المستخدم حالياً لدراسة الدماغ خلال قيامه بعملية إنتاج الكلام وفهمه وتخزينه.
آليات تطور النشاط اللغوي عند الأطفال
لفترة طويلة، كان الطفل يعتبر بالغًا غير مكتمل: من خلال ملاحظة «إعاقاته» بدلاً من مهاراته، على سبيل المثال، من حيث التفكير أو الاستقلالية، في إشارة إلى الإنجاز الذي يمثله الشخص البالغ. واليوم يوفر لنا علم النفس المعاصر (علم النفس العصبي)، مع الأساليب المتجددة للمراقبة والتجريب، فهماً أفضل للتطور، وتحليل التغيّرات طوال الحياة، منذ الولادة وقبلها حتى الموت. ويدرس علم النفس التنموي الخصائص العامة للتطور والاختلافات بين الأفراد.
إنَّ عملية فهم التطور هي عملية معقّدة. ولفهمها، تتلاقى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها قدرة تنمية الدماغ، ثم تطور العمليات المعرفية والعاطفية، وأخيراً فهم العوامل البيئية التي تؤثر في هذه العملية.
ويجري التحكم في نمو الدماغ من خلال مبدأين: التطور الجيني، وتطور البيئة النفسية والاجتماعية والثقافية. وتتفاعل هاتان العمليتان لتعديل نمو الدماغ في مراحل مختلفة من حياة ما قبل الولادة وبعدها. وإضافة إلى البرامج الجينية للدماغ في مرحلة النمو، تؤدي البيئة دوراً رئيسياً في الآليات التي تتحكم في نمو الدماغ.
وتتكون عملية فهم وظيفة الدماغ من جراء تطور تقنيات استكشاف الدماغ أثناء الفعل، فقد تم إبراز المناطق الدماغية (Cerebral Mantle) للغة لأول مرة عبر كاميرا الپوزیترون Positron.
عندما يستمع الطفل إلى الأصوات، تتفاعل المنطقة الصدغية العلوية للدماغ، فيما تنشّط القراءة الصامتة عملية التعرّف البصري إلى الكلمات في الجزء الخلفي من الدماغ. وعندما يسأل عن المعاني، نلاحظ تنشيط الجبهة الداخلية اليسرى الأمامية من الدماغ (Inferior Frontal Gyrus) التي تقع في الجزء الأمامي خلف الجبهة. مثلاً، عندما نريه صورة «عصفور» ونقول له كلمة «شمس». بهذه العملية، يبني الطفل تدریجاً مفردات تسمى المعجم الذهني، الذي يتطور ليشكّل شبكة من الكلمات منظمة دلالياً. هذا التنظيم في شبكة دلالية يتعلق بتكوين الذاكرة التي تعمل بطريقة ترابطية (أي من طريق الربط بين الأشياء المختلفة بهدف إقامة علاقة بينها)، والكلمات مرتبطة بما تسميه الحقل الدلالي (وهو مجموعة من الكلمات ذات صلة في المعنى. مثلاً كلمة «حريق» تشكل حقلاً دلالياً فيه كلمات مثل «نار» و«إسعاف»..). وبتنشيط الشبكة الدلالية (تمثل العلاقة الدلالية بين المفاهيم وتعمل بطريقة ترابطية)، تسهل عملية إدراك كلمة ما والوصول إلى معنی كلمة أخرى مرتبطة بها لغوياً (مثلاً، عندما يدرك الفرد معنى كلمة «طبيعة» ستنشط لديه الشبكة الدلالية، وتستدرج کلمات أخرى تشكل عناصر الطبيعة. على سبيل المثال، غابة وأشجار…).
من المؤكد أن اللغة هي النشاط الإنساني الأكثر تعقيداً، ودراستها لا تزال غير منتهية ونهائية، بل هي في بدايتها فيزيولوجيا. وفي السنوات الثلاثين الأخيرة، اهتمت دراسات كثيرة بذلك، وانصب هذا الاهتمام بمجمله على الخطاب، والكلام الصادر عن الأفراد بشكل عفوي، وكان أكثره متعلقاً بمنهجيات الألسنية وعلوم اللغة. أما الدراسات الحالية الناتجة عن علم النفس المعرفي، فترتكز على قياس زمن رد الفعل والتفاعلات. وقد ساعد ذلك في تثبيت وتحديد الطرق المعتمدة. كما أن تقنيات التصوير والرنين المغنطيسي حلّت بعض العقد، ولكنها زادت من التعقيدات في الوقت نفسه.
أهمية الذاكرة الرقمية
لم تتّضح حتى يومنا هذا، طريقة تشفير المعلومات النحوية داخل شبكة الدماغ، إذ لا يسعنا – حالياً – الوصول إلى الشيفرة العصبية المفضّلة، في كل جزء من المعلومات التي توفرها كل خلية عصبية، أي أنه من الصعب معرفة محتوى كل خلية دماغية كمعرفتنا بالذاكرة الرقمية، لأننا نعرف، وبالتفصيل، أين يقع الصفر وأين يقع الواحد (Binary Code) في ذاكرة الحاسوب، فلكل وحدة قياس معلومات رقمية (Bit) نستطيع معرفة مكان وجودها، لأن لها عنواناً محدداً في ذاكرة الكومبيوتر، وهو لا يزال بعيداً كل البعد عن معرفتنا بخلايا الدماغ وموقعها عند استرجاع الكلام أو عند تخزينه.
وتُظهر البحوث الحديثة وجود نظامين عصبیین متمایزین، على الأقل، يشاركان في القراءة. يقرأ الدماغ في المقام الأول عن طريق ترجمة الأحرف المكتوبة إلى العناصر الصوتية المقابلة لها في اللغة الشفوية، لكنه يقيم أيضاً صلة بين الصورة الكاملة للكلمة المكتوبة ومعناها، وهو تذکیر یمکنه، بطريقة ما، تجاوز التطابق مع التوقيع الصوتي للكلمة.
وعلى الرغم من الدراسات المتعددة والتطورات التقنية، لا يزال فهم الدماغ ثنائي اللغة قيد التجارب، ويصعب التعامل مع ثنائية اللغة كظاهرة فريدة، بسبب تداخل كثير من المتغيرات مع التنظيم الوظيفي.
بحسب عالم النفس دانیال کانیمان، إن أدمغتنا تعمل من خلال نظامين: النظام الأول، ينشط بسهولة أكبر في لغتنا الأم، وهو يعطي ردوداً بديهية أسرع وأكثر كفاءة ولكنه يرتكب كثيراً من الأخطاء. النظام الآخر، يتميز باستخدامه المنطق، وهو النظام الأكثر كسلاً ينشط من خلال الجهد الإضافي المطلوب لاستخدام لغة أخرى.
لقد اهتم العرب كثيراً بعلم المنطق، وهو، كما كان في زمن الفلاسفة القدماء أداة للقياس، ولكن من دون أن يكون محدداً برموز رياضية. وقد عبّر عنه الفارابي كذلك في كتابه «إحصاء العلوم عند الفارابي»، إذ يقول إن صناعة المنطق تعطي جملة من القوانين التي تقوّم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يخطىء فيه من المعقولات.
أما المشكلة التي يعانيها الغرب حالياً، فهي معلوماتية الأشياء (أي أن تصبح كل الأدوات تحرّك عن بعد)، والنظام الرأسمالي الذي لا يهتم بالفرد كإنسان، بل كرقم (يهتم بما ينتجه الفرد)، والسرعة التي باتت تتحكم في سلوكيات المجتمعات الغربية، كلّها تشكل خطراً على الإنسان. إلا أن مفهوم الثورة هو انتقال من نموذج فكري قياسي إرشادي (براديغم) نظرية فلسفية، إلى آخر، وهو إعلان صریح لحلول الوعي التاريخي، الذي يعتمد في مقاربته المفاهيمية على فلسفة العلوم. والعلم نمط من المعرفة يستند إلى الملاحظات التجريبية لوقائع العالم، لعلها تساعده في السيطرة على بيئته وإحكام تعامله مع عالمه.
أما عالم النفس في جامعة ولاية كاليفورنيا لاري روزين، فيعتبر أن الهواتف الذكية لها تأثير كبير في سلوكنا. وقد أجرى اختباراً لتحديد عدد المرات التي نظر فيها المشاركون إلى هواتفهم، وتبين أنهم في المتوسط ينظرون إلى هواتفهم ستين مرة في اليوم تقريباً، وتستغرق كل جلسة حوالى ثلاث دقائق إلى أربع دقائق، أي ما مجموعه مئتان وعشرون دقيقة في اليوم. إن هذا الوقت الذي نصرفه في النظر إلى الهاتف له تأثير في انتباهنا لما حولنا، ويعرقل النشاط المتواصل في الحياة اليومية، كما أنه يفقدنا الشعور بالوقت.
أما من الناحية النفسية، فإن الوقت هو تمثيل ذهني يتعلق بالإحساس بأن الوقت يمر بسرعة عندما نشعر بأننا بخير، وأن الوقت يمشي ببطء عندما نشعر بالملل. كل ذلك يتعلق بالوعي للوقت بحسب الساعة البيولوجية والساعة الداخلية للأفراد. ونشیر إلى أن اهتمام هذا النص هو التنبّه إلى الوقت المتعلق بفترات العمل فقط، ولا ندخل في مناقشة مسألة الوقت من النواحي الفيزيائية والنفسية والاجتماعية أو غيرها، لأننا نعلم جيداّ أن الوقت و/أو الزمن له تعریف خاص يتعلق بكل مجال.
الرقمنة والتحول الرقمي والبرمجيات
يتضمن التحول الرقمي النظر في تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة، ليس من منظور الاختيار البسيط للأداة، ولكن باعتبارها قضية اقتصادية واجتماعية استراتيجية حقيقية، إذ تعمل الرقمنة والتحول الرقمي بشكل جماعي، وينطبق ذلك ويطبق على المجتمع بشكل عام. إن التحول الرقمي يعني توسيع نطاق التغيير ودعمه الذي ينطوي عليه اختيار التكنولوجيا وتنفيذها، مع مراعاة مفاهیم التحكّم في الاستخدام وإدارة التغيير والحوكمة والتعليم والتدريب والتعلّم…
كما أن تداخل المعلوماتية والتقنيات بشكل عام مع العلوم الإنسانية والاجتماعية والإعلامية أضحى من المسلمات. وهذا ما يؤدي إلى طرح السؤال، هل من المفترض أن تعدل مناهج التعليم لتدريس الإعلام، بما يخص النص أولاً؟ وما يصاحبه من عناصر محاذية للنص (paratextuels) (عناوين وصور وفيديوهات وغيرها).
إن التغيّرات الحاصلة في عالم الإعلام تحتّم على العاملين فيه معرفة بناء المنصّات الرقمية وتصميم خوارزميات تتعلّق بمهنة الصحافي – الرقمي؛ ففي الإعلام على أنواعه باتت التطبيقات الرقمية حاجة ضرورية، إضافة إلى معرفة أدوات البحث والتنقيب. كما أن البحوث المستقبلية في هذه التطبيقات ترتبط بما يُسمّى تقنيّات المعالجة الآلية للّغة من ناحية، وكل ما له علاقة بمفهوم الإنسانيات الرقمية، التي هي عبارة عن مغهوم يتعلّق بالتجديد في العلوم الإنسانيّة والإعلاميّة؛ أي بناء علوم جديدة تهدف إلى بناء مفاهيم جديدة تتماشى مع التغيّرات الرقمية.
كتاب “مرايا التحولات الرقمية” هو عبارة عن مجموعة إشكاليات مترابطة في ما بينها من حيث صلتها بالعالم الرقمي الجديد. وفي الوقت عينه يمكن اقتطاع أي منها من السلسلة وقراءتها على حدة، كما يحدد المؤلف، لأنها تعالج بشكل أفقي المشكلات التقنية في جيل واحد، ويمكن للقارىء أن ينتقي ما يريد. فقراءة هذا الكتاب تتوافق مع ثقافة القراءة الإلكترونية التشعبية، ومع ثقافة المتلقي، الانتقائية حالياً.
المصدر الميادين